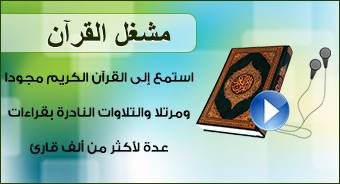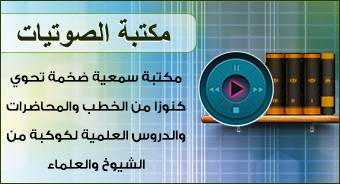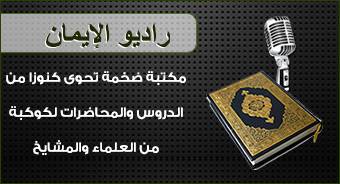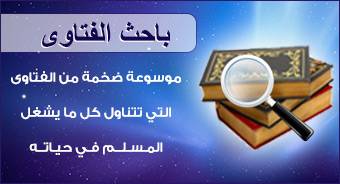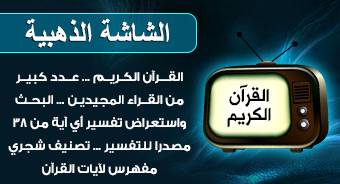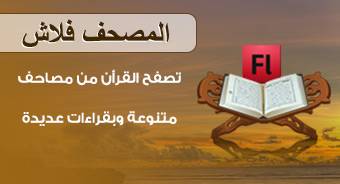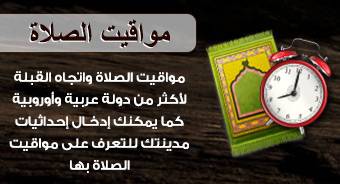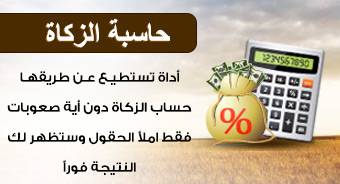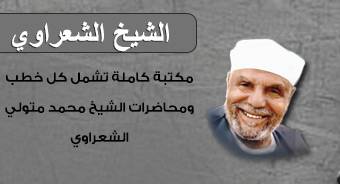|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
وليس تحت هذه الألفاظ كثير معنى، وهي رائقة معجبة، وإنما هي: ولما قضينا الحج، ومسحنا بالأركان، وشدت رحالنا على مهازيل الإبل، ولم ينتظر بعضنا بعضاً، وجعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية؛ وإذا كان المعنى صواباً واللفظ بارداً فاتراً كان مستهجناً ملفوظاً، ومذموماً مردوداً، كقول أبي العتاهية في أبي عثمان سعيد بن وهبٍ. الوجه الثاني الألفاظ المفردة وبيان ما ينبغي استعماله منها وما يجب تركه اعلم أن الذي ينبغي أن يستعمل في النظم والنثر من الألفاظ هو الرائق البهج الذي تقبله النفس، ويميل إليه الطبع، وهو الفصيح من الألفاظ دون غيره.والفصيح في أصل اللغة هو الظاهر البين، يقال: أفصح الصبح إذا ظهر وبان ضوؤه، وأفصح اللبن إذا تجلت عنه رغوته وطهر، وأفصح الأعجمي وفصح إذا أبان بعد أن لم يكن يبين، وأفصح الرجل عما في نفسه إذا أظهره.قال في المثل السائر: وأهل البيان يقفون عند هذا التفسير، ولا يكشفون عن السر فيه. قال: وبهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة، لأنه يلزم أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهراً بينا لم يكن فصيحاً جيداً، ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحاً؛ على أنه قد يكون اللفظ ظاهراً لزيد ولا يكون ظاهراً لعمرو، فيكون فصيحاً؛ على أنه قد يكن اللفظ ظاهراً لزيد ولا يكون ظاهر لعمرو، فيكون فصيحاً عند واحد دون آخر، وليس كذلك؛ بل الفصيح مالم يختلف في فصاحته، لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ المختص بها خلاف؛ وأيضاً فإنه لوجيء بلفظ فبيح ينبو عنه السمع، وهو مع ذلك ظاهر بين، فينبغي أن يكون فصيحاً، وليس كذلك؛ لأن الفصاحة وصف حسن اللفظ لا وصف قبحه.قال: وتحقيق القول في ذلك أن يقال: الكلام الفصيح هو الظاهر البين، والظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة لا يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتب لغة؛ وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر، دائرةً في كلامهم؛ وإنما كانت مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر، دائرة في كلامهم؛ وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنها، وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها، وسبروا وقسموا فاختاروا الحسن من الألفاظ فاستعملوه، ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه؛ فحسن الألفاظ سبب استعمالها دون غيرها، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها؛ فالفصيح إذا من الألفاظ هو الحسن. ثم قال: والمرجع في تحسين الألفاظ وقبحها إلى حاسة السمع، فما يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن، وما يكرهه وينفر عنه هو القبيح، وبدليل أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويميل إليهما، ويكره صوت الغراب وينفر عنه، وكذلك يكره نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفرس؛ والألفاظ جارية هذا المجرى؛ فإنه لا خلاف في أن لفظه المزنة والديمة يستلذهما السمع، ولفظه البعاق قبيحة يكرهها السمع، والألفاظ الثلاثة من صفة المطر ومعناها واحد؛ وأنت ترى لفظتي المزنة والديمة وما جرى مجراهما مألوفة الاستعمال، وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكاً لا يستعمل، وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير سليم، لا جرم أنه ذم وقدح فيه، ولم يلتفت إليه، وإن كان عربياً محضاً من الجاهلية الأقدمين؛ فإن حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على ما خرج عنها.إذا علمت ذلك فلا يوصف اللفظ المفرد بالحسن حتى يتصف بأربع صفات: الصفة الأولى ألا يكون غريباً؛ وهو ما ليس مأنوس الاستعمال ولا ظاهر المعنى.ويسمى: الوحشي أيضاً، نسبة إلى الوحش النفاوه وعدم تأنسه وتألفه، وربما قلب فقيل: الحوشي، نسبة إلى الحوش، وهو النفار.قال الجوهري: وزعم قوم أن الحوش بلاد الجن وراء رمل يبرين لا يسكنها أحد من الناس، فالغريب والوحشي والحوشي كله بمعنى.ثم الغريب على ضربين:الضرب الأول: ما يعاب استعماله مطلقاً:وهو ما يحتاج في فهمه إلى بحث وتنقيب، وكشف من كتب اللغة؛ كقول ابن جحدر. فالإرقال: ضرب من السير؛ وهو نوع من الخبب، يقال منه: أرقلت الناقة ترقل إرقالاً، والهمرجلة: الناقة السريعة، وقال أبو زيد: الهمرجلة: الناقة النجيبة الراحلة. والشيظم: الشديد الطويل، وهو من صفات الإبل والخيل والأنثى شيظمة. والشبرقة: القطع، يقال: شبرقت الثوب أشبرقه شبرقة إذا قطعته، وشبرقت الطريق إذا قطعتها. والتنوفة: المفازة، ويقال فيها: تنوفية أيضاً. والوحي هنا. الصوت الخفي، يقال: سمعت وحاة الرعد، وهو صوته الممتد الخفي.وقوله زيز يزم: حكاية لأصوات الجن إذا قالت: زي زي، وحاصله أنه يقول: حلفت هذه الحلفة بما سارت هذه الناقة الشديدة السير العظيمة الخلف، وما قطعت من مفازة لا يسمع فيها إلا أصوات الجن؛ وهذا مما لا يوقف على معناه إلا بكد وتعب في كشفه وتتبعه من كتب اللغة.الضرب الثاني: ما يحتاج إلى تدقيق النظر في التصريف وتخريج اللفظ على وجه بعد:كلفظ مسرج من قول العجاج. فالمقلة: شحمة العين. والحاجب معروف. والمزجج: المقوس مع طول ودقة في طرفه. والفاحم: الشعر الأسود الذي لونه كلون الفحم. والمرسن: الأنف، وصفه بكونه مسرجاً إما أنه كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، والسريجي نسبة إلى قين يسمى سريجاً تنسب إليه السيوف؛ وإما أنه كالسراج في البريق واللمعان، أو من قولهم سرج الله وجهه إذا بهجه وحسنه. فهذا ومثله مما لا يقف على معناه إلا من عرف التصريف وأتقنه.إذا تقرر ذلك فاعلم أن اللفظ يختلف في الغرابة وعدمها باختلاف النسب والإضافات؛ فقد يكون اللفظ مألوفاً متداول الاستعمال عند كل قوم في كل زمن، وقد يكون غريباً متوحشاً في زمن دون زمن، وقد يكون غريباً متوحشاً عند قوم، مستعملاً مألوفاً عند آخرين.وهو أربعة أصناف:الصنف الأول المألوف المتداول الاستعمال عند كل قوم في كل زمن وهو ما تداول استعماله الأول والآخر من الزمان القديم وإلى زننا: كالسماء والأرض، والليل والنهار، والحر والبرد، وما أشبه ذلك؛ وهو أحسن الألفاظ وأعذبها، وأعلاها درجة، وأعلاها قيمةً؛ إذا أحسن اللفظ ما كان مألوفاً متداولاً كما تقدم؛ وهذا لا يقع عليه اسم الوحشي بحال.قال في المثل السائر: وأنت إذا نظرت إلى كتاب الله العزيز الذي هو أفصح الكلام وجدته سهلاً سلساً، وما تضمنه من الكلمات الغريبة يسير جداً.هذا وقد أنزل في زمن العرب العرباء، وألفاظه كلها من أسهل الألفاظ وأقربها استعمالاً وكفى بالقرآن الكريم قدوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني يريد فاتحة الكتاب. وإذا نظرت إلى ما اشتملت عليه من الألفاظ وجدتها سهلة قريبة يفهمها كل أحد حتى صبيان المكاتب وعوام السوقة وإن لم يفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبلاغة، فإن أحسن الكلام ما عرف الخاصة فضله، وفهم العامة معناه؛ وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة في سهولة فهمها وقرب متنأولها؛ والمقتدي بألفاظ القرآن يكتفي بها عن غيرها من جميع الألفاظ المنثورة والمنظومة؛ وقد كانت العرب الأول في الزمن القديم تتحاشى اللفظ الغريب في نظمها ونثرها، وتميل إلى السهل وتستعذ به؛ ويكفي من ذلك كلام قبيص بن نعيم لما قدم على امرئ القيس في أشياخ بني أسد يسألونه العفو عن دم أبيه، فقال له: إنك في المحل والقدر من المعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه، وتنتقل به أحواله، بحيث لا تحتاج إلا تذكير من واعظ، ولا تبصير من مجرب؛ ولك من سودد منصبك، وشرف أعرافك، وكرم أصلك في العرب محتد يحتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة ورجوع عن الهقوة؛ ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا رجعت إليك فوجدت عندك من فضيلة الرأي، وبصيرة الفهم، وكرم الصفح، ما يطول رغباتها، ويستغرق طلباتها، وقد كان الذي كان من الخطب الجليل، الذي عمت رزيته نزاراً واليمن، ولم تخصص بذلك كندة دوننا للشرف البارع الذيلحجر؛ ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا بها على مثله، ولكنه مضى به سبيل لا يرجع أخراه على أولاه، ولا يلحق أقصاه أدناه؛ فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خلالٍ ثلاث: إما أن اخترت من بني أسدٍ أشرفها بيتاً، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً، فقدناه إليك بنسعة تذهب مع شفرات حسامك بباقي قصرته فنقول: رجل امتحن بهالك عزيز فلم يستل سخيمته إلا تمكينه من الانتقام؛ أو فداء بما يروح على بني أسد من نعمها، فهي ألوف تجاوز الحسبة، فكان ذلك فداءً رجعت به القضب إلى أجفانها، لم يرددها تسليط الاحن على البرآء؛ وإما أن وادعتنا إلى أن تضع الحوامل فتسدل الأزر وتعقد الخمر فوق الرايات.فبكى امرء القيس ساعةً، ثم رفع رأسه فقال: ولقد علمت العرب أنه لا كفء لحجر في دم، وأني لن أعتاض به جملاً ولا ناقة، فأكتسب به سبة الأبد، وفت العضد، وأما النظرة فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها، ولن أكون لعطبها سبباً، وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك، تحمل في القلوب حنقاً، وفوق الأسنة علقاً: أتقيمون أم تنصرفوون؟ قالوا: بل ننصرف بأسوإ الاختيار وأبلى الاجترار، بمكروه وأذية، وحرب وبلية.ثم نهضوا عنه وقبيصة يتمثل: فقال امرء القيس: لا والله! ولكن استعذبه، فرويداً ينفرج لك دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير، ولقد كان ذكر غير هذا بي أولى إذا كنت نازلاً بربعي، ولكنك قلت فأوجبت.فقال قبيصة: ما يتوقع فوق قدر المعاتبة والإعتاب، فقال إمرؤ القيس: هو ذاك.قال في المثل السائر: فلينظر إلى هذا الكلام من الرجلين قبيصة وامرئ القيس، حتى يدع المتعمقون تعمقهم في استعمال الوحشي من الألفاظ؛ فإن هذا الكلام قد كان في الزمن القديم قبل الإسلام بما شاء الله، وكذلك هو كلام كل فصيح من العرب مشهور، وما عداه فليس بشيء. قال: وهذا المشار إليه هاهنا هو من جزل كلامهم، وهو على ما تراه من السلاسة والعذوبة؛ وإذا تصفحت أشعارهم أيضاً وجدت الوحشي من الألفاظ قليلاً بالنسبة إلى المسلسل في الفم والسمع؛ وعلى هذا المنهج في الجزالة والسهولة يجري من النظم قول امرئ القيس: فانظر إلى هذين البيتين ليس فيهما لفظة غريبة، ولا كره مع ما فيهما من الجزالة؛ وكذلك ابيات السموال المشهورة وهي: فإذا نظرت ما تضمنته هذه الأبيات من الجزالة، خلتها زبراً من الحديد مع ما هي عليه من السهولة والعذوبة، وأنها غير فظة ولا غليظة. وقد ورد للعرب في جانب الرقة من الأشعار ما يكاد تذوب لرقته القلوب، كقول عروة بن أذينة: وقول يزيد بن الطثرية في محبوبته من بني جرم: وإذا كان هذا قول ساكن الفلاة، لا يرى إلا شجحية أو قيصومة، ولا يأكل إلا ضبا أو يربوعاً، فما بال قوم سكنوا الحضر، ووجدوا رقة العيش، يتعاطون وحشي الألفاظ وشظف العبارات؟ ولا يخلد إلى ذلك إلا جاهل بأسرار الفصاحة، أو عاجزً عن سلوك طريقها، فإن كل أحد ممن حصل على نبذةٍ من علم الأدب يمكنه أن يأتي بالوحشي من الكلام، إما بأن يلتقطه من كتب اللغة، أو يتلقفه من أربابها. وأما الفصيح المتصف بصفة الملاحة، فإنه لا يقدر عليه، ولو قدر عليه لما علم أين يضع يده في تأليفه وسبكه.قال: وإن مارى في ذلك ممارٍ فلينظر إلى أشعار علماء الأدب ممن كان يشار إليه حتى يعلم صحة ذلك، فإن ابن دريد قد قيل أنه أشعر علماء الأدب، وإذا نظرت إلى شعره وجدته بالنسبة إلى شعر الشعراء المجيدين منحطاً، مع أن أولئك الشعراء لم يعرفوا من علم الأدب عشر معشار ما علمه؛ وأين شعره من شعر العباس ابن الأحنف! وهو من أوائل الشعراء المحدثين، وشعره كمر نسيم على عذبات أغصان، أو كلؤلؤات طل على طرر ريحان؛ وليس فيه لفظة واحدة غريبة يحتاج إلى استخراجها من كتاب من كتب اللغة، كقوله: وهل أعذب من هذه الأبيات، وأعلق بالخاطر، وأسرى في السمع؟ ولمثلها تسهر راقدات الأجفان، وعن مثلها تتأخر السوابق عند الرهان، ومن الذي يستطيع أن يسلك هذه الطريق التي هي سهلة وعرة، قريبة بعيدة؟. وقد كان أبو العتاهية أيضاً في غرة الدولة العباسية، وشعر العرب إذ ذاك موجود كثيراً، وإذا تأملت شعره وجدته كالماء الجاري، رقة ألفاظ، ولطافة سبك، وليس بركيك ولا واه، وانظر إلى قصيدتة التي يمدح بها المهدي ويشبب بجاريته عتب وهي: فلما وصل إلى المديح قال من جملته: وسهولته، كقوله في محبوته جنان: فانظر إلى هذه الأبيات ليس فيها لفظة منغلقة، وكذلك سائر شعره؛ وكان هو وأبو العتاهية كأنما ينفقان من كيس واحد. ومن لطيف ما يحكى في توافق طريقتهما واتحاد مأخذهما أن أبا نواس جلس يوماً إلى بعض التجار ببغداد هو وجماعة من الشعراء، فاستسقى أبو نواس ماء فلما شرب قال: ثم قال: أجيزوه! فأخذ أولئك الشعراء يترددون في إجازته، وإذا هم بأبي العتاهية مجتازاً فقالك ما شأنكم مجتمعين؟ فقالوا كيت وكيت وقد قال أبو نواس: فقال أبو العتاهية مجيزاً له: فعجبوا لقوله على الفور من غير تلبث، فهذا هو الكلام السهل الممتنع تراه يطمعك أن تأتي مثله، فإذا حأولت مماثلته راغ عنك كما يروغ الثعلب، وهكذا ينبغي أن يكون من خاض في كتابه أو شعر، فإن خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن.ومن النثر قول سعيد بن حميد: وأنا من لا يحاجك عن نفسه، ولا يغالطك عن جرمه، ولا يستدعي برك إلا من طريقته، ولا يستعطفك إلا بالإقرار بالذنب، ولا ستميلك إلا بالاعتراف بالجرم، نبت بي عنك غرة الحداثة، وردتني إليك الحنكة، وباعدتني منك الثقة بالأيام، وقادتني إليك الضرورة، فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر، وتجدد النعمة باطراح الحقد، فإن قديم الحرمة وحديث التوبة يمحقان ما بينهما من الإساءة؛ وإن أيام القدرة وإن طالت قصيرة، والمتعة بها وإن كثرت قليلة، فعلت إن شاء الله تعالى.فانظر إلى قوة هذا الكلام في سهولته، وقرب مأخذه مع بعد تنأوله والإتيان بمشاكله. وأجزال منه مع السهولة قول الشعبي للحجاج، وأراد قتله لخروجه عليه مع ابن الأشعث: أجدب بنا الجناب، وأحزن بنا المنزل، فاستحلسنا الحذر، واكتحلنا السهر، وأصابتنا فتنة لم نكن فيهابررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء فعفا عنه.قال صاحب الصناعتين: وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا علىمعناه إلا بكد، وستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة، وجاسية مريبة، وستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذاباً، وسهلاً حلواً؛ ولم يعلموا أن السهل أمنع جانباً، وأعز مطلباً، وهو أحسن موقعاً، وأعذب مستمعاً؛ ولهذا قيل: أجود الكلام السهل الممتنع وكان المفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له، ويكثر الغريب فيه. قال العسكري: وهذا خطأ في الاختيار، لأن الغريب لم يكثر في كلام إلا أفسده، وفيه دلالة على الاستكراه والتكلف.ووصف الفضل بن سهلٍ عمرو بن مسعدة فقال: هو أبلغ الناس، ومن بلاغته أن كل أحد يظن أنه يكتب مثل كتبه، فإذا رامها، تعذرت عليه.وقال العباس بن ميمون: قلت للسيد: ألا تستعمل الغريب في شعرك؟ فقال: ذلك عي في زماني، وتكلف مني لو قلته، وقد رزقت طبعاً واتساعاً في الكلام، فأنا أقول ما يعرفه الصغير والكبير، ولا يحتاج إلى تفسير، ثم أنشدني: قال في الصناعيتن: فهذا كلام عاقلٍ يضع الكلام موضعه، ويستعمله في إبانه.ومن كلام بعض الأوائل: تلخيص المعاني رفق، والتشادق في غير أهل نقص، والنظر في وجوه الناس عي، ومس اللحية هلك، والاستعانة بالغريب عجز، والخروج عما بني عليه الكلام إسهاب؛ فأجود الكلام ما كان جزلاً سهلاً، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا يكون مكدوداً مستكرهاً، ومتوعراً متقعراً، ويكون بريئاً من الغثاثة، عارياً من الرثاثة؛ فالكلام إذا كان فظه غثا، ومعرضه رثا، كان مردوداً احتوى على أجل معنى وأنبله، وأرفعه وأفضله. قال في المثل السائر: أما البداوة والعنجهية، فتلك أمة قد خلت، ومع أنها قد خلت وكانت في زمن العرب العاربة فإنها قد عيبت على مستعملها في ذلك الوقت، فكيف الآن وقد غلب على الناس رقة الحضر.الصنف الثاني الغريب المتوحش عند كل قوم في كل زمان وهو ما لم يكن متداول الاستعمال في الزمن الأول ولا ما بعده، بل كانمرفوضاً عند العرب كما هو مرفوض عند غيرهم، ويسمى الوحشي الغليظ، والعكر، والمتوعر؛ وهو على ثلاثة أضرب:الضرب الأول ما يعاب اسعماله في النظم والنثر جميعاً:قال في المثل السائر: والناس في قبح استعماله سواء، لا يختلف فيه عربي باد، ولا قروي متحضر. قال وليس وراءه في القبح درجة أخرى، ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن أصلاً، وهو ما مجه سمعك، ونبا عنه لسانك؛ وثقل عليك النطق به؛ على أنه قد وقع منه ألفاظ لبعض الشعراء المفلقين من العرب والمحدثين. فمن ذلك لفظ الجحيش في قول تأبط شراً من أبيات الحماسة: قال في المثل السائر: ويالله العجب! أليس أنها بمعنى فريد؟ وفريد لفظه حسنة رائقة، لو وضعت في هذا البيت موضع جحيشٍ لما اختل شيء من وزنه، فتأبط شراً ملوم من وجهين: أحدهما استعماله القبيح، والثاني أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم يعدل عنها؛ وأقبح من ذلك لفظ اطلخم في قول أبي تمام: فإن لفظة اطلخم من الألفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين: من أنها غريبة، وأنها غليظة في السمع، كريهة على الذوق، وكذلك لفظة دهاريس في آخر البيت المذكور.وعلى حد ذلك ورد لفظ جيدر في قوله من أبيات في وصف فرس: فلفظة جيدر وحشية غليظة؛ وأغلظ منها لفظة جفخت في قول أبي الطيب المتنبي. فإن لفظة جفخ مرة الطعم، وإذا مرت على السمع اقشعر منها، وكان له مندوحة عن استعمالها، فإن جفخت بمعنى فخرت وهما في وزن واحد، فلو أتى بلفظ فخرت ويفخرون مكان جفخت ويجفخون لا ستقام وزن البيت وحظي في استعماله بالأحسن، فهو في ذلك كتأبط شراً في لفظة جحيش في توجه الملامة عليه من وجيهن.قال في المثل السائر: وما أعلم كيف بذهب هذا وأمثاله على هؤلاء الفحول من الشعراء! هذا ما أورده الأثير من هذا النوع، ويشبه أن يكون منه لفظ الحقلد في قول زهير: والحقلد: السيئ الخلق.قال في الصناعتين: وقد أخذ الرواة على زهير في لفظة الحقلد فاستبشعوها، وقالوا: ليس في لفظ زهير أنكر منها، وكذلك لفظ الجرشى في قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة بن حمدان واسمه علي: فلفظ الجرشى مما يكرهه السمع، وينبو عنه اللسان، والجرش بمعنى النفس، فجعل اسمه مباركاً، ولقبه أغر، ونفسه كريمة، ونسبه شريفاً، وذكل أنه كان يسمى علياً وهو اسم مبارك لموافقة اسم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، ويلقب سيف الدولة وهو لقب أعرابي مشهور، وأغر أخذاً من غرة الفرس لأنها أشهر ما فيها، ووصفه بكرم النفس إما باعتبار الحسب والعراقة، وإما باعتبار بذل المال وكثرة العطاء، وأشار إلى شرف نسبه باعتبار عراقته في بيت الملك وعراقة حسبه.الضرب الثاني ما يعاب استعماله في النثر دون النظم:ولربما أنكره بعد ذلك إما عناداً وإما جهلاً لعدم الذوق السليم عنده، ثم ذكر منه أمثلة، منها لفظ شرنبثة من قول الفرزدق: قال: فلفظة شرنبثة من الألفاظ الغريبة التي يسوغ استعمالها في العشر، وهي ها هنا غير مستكرهة، إلا أنها لو وردت في كلام منثور من كتاب أو خطبة لعيبت علىمستعملها.ومنها لفظة مشمخر الواردة في أبيات بشر في وصفه لقاءه الأسد حيث قال: وكذلك في قول البحتري في قصيدته التي يصف فيها إيوان كسرى: فإن لفظة مشمخر لا يحسن استعمالها في الخطب والمكاتبات، ولا بأس بها في الشعر؛ وقد وردت في خطب الشيخ الخطيب ابن نباتة كقوله في خطبة يذكر فيها أهوال يوم القيامة: اقمطر وبالها، واشمخر نكالها، فما طابت ولا ساغت.ومنها لفظة الكنهور من أوصاف السحاب كقول أبي الطيب: فلفظة الكنهور لا تعاب نظماًن وتعاب نثراً.ومنها لفظة العرمس، وهو اسم الناقة الشديدة؛ فغن هذه اللفظة يسوغ استعمالها في الشعر ولا يعاب مستعملها كقول المتنبي: فإنه جمع هذه اللفظة ولا بأس بها، ولو استعملت في الكلام المنثور من الخطب لما طابت ولا ساغت؛ وقد جاءت موحدة في شعر أبي تمام في قوله: ومنها لفظة الشدنية في قول أبي تمام أيضاً: وهي ضرب من النوق؛ فإن الشدنية لا تعاب شعراً وتعاب لو وردت في كتابة أو خطبة. هذا ما أورده في المثل السائر لهذا الضرب من الأمثلة.ثم قال: وهكذا يجري الحكم في أمثال هذه الألفاظ؛ وعلى هذا فاعلم أن كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنثور يسوغ استعماله في الكلام المنظوم، وليس كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله في الكلام المنثور. قال: وذلك شيء استنبطته واطلعت عليه لكثرة ممارستي هذا الفن، ولأن الذوق الذي عندي دلني عليه، فمن شاء أن يقلدني فيه، وإلا فليدمن النظر حتى يطلع على ما اطلعت عليه، والأذهان في مثل هذا المقام تتفاوت. على أن الشيخ سعد الدين التفتازاني رحمه الله قد تابعه على ذلك في شرح التلخيص، فلا أعلم أقلده في ذلك أم ذوقه أداه إليه؟الضرب الثالث ما يعاب استعماله بصيغة دون صيغة:قال في المثل السائر: وهو الضرب من هذه الصناعة بمنزلة علية، ومكانةٍ شريفة، وجل الأسرار اللفظية منوط به. قال: وقد لقيت جماعة من مدعي فن الفصاحة وفاوضتهم وفاوضوني، وسألتهم وسألوني، فما وجدت أحداً منهم يتقن معرفة هذا الموضع كما ينبغي؛ وقد استخرجت فيه أشياء لم أسبق إليها؛ فإن الفظة الواحدة قد تنتقل من هيئة إلى هيئة، أو من صفة إلى صفة، فتنتقل من القبح إلى الحسن وبالعكس فيصير القبيح حسناً، والحسن قبيحاً، المرجع في ذلك إلى الذوق الصحيح والطبع السليم؛ وقد نبه منه على تسعة أنماط:النمط الأول: ما يترجح فيه الاسم في الاستعمال على الفعل، وذلك في مثل لفظ خود، فإنها عبارة عن المرأة الناعمة، فإذا نقلت إلى صيغة الفعل، قيل خود على وزن فعل بتشديد العين، ومعناها أسرع. يقال: خود البعير إذا أسرع في مشيه، فهي على صيغة الاسم حسنة رائقة، قد وردت في النظم والنثر كثيراً، وإذا جاءت على صيغة الفعل لم تكن حسنة، كقول أبي تمام: إلا أن لفظة خود قد استعملت على غير هذا الوجه في بعض الواضع فزال عنها بعض القبح وإن تلحق بدرجة الرائق الحسن، كقول بعض شعراء الحماسة: والرأل: النعام، والمراد أن نفسه فرت وغزعت، شبه بإسراع النعام في فراره وغزعه، فلما أورد ذلك على سبيل المجاز زال بعض القبح.قال: وهذا يدركه الذوق الصحيح، فهي في بيت أبي تمام قبيحة سمجة، وهاهنا بين بين، ويقاس على ذلك أشباهه ونظائره.النمط الثاني: ما يترجح فيه فعل الأمر والمستقبل في الاستعمال على الفعل الماضي وذلك في مثل لفظة ودع، وهي فعل ماض ثلاثي لا ثقل بها على اللسان، ومع ذلك فإنها لا تستعمل على صيغتها الماضية إلا جاءت غير مستحسنةٍ، فإذا استعملت على صيغة الأمر أو الاستقبال جاءت حسنة بهجة رائقة؛ أما على صيغة الأمر فكما في قوله تعالى: {فذرهم يخوضوا ويلعبوا} ولم ترد في القرآن الكريم إلا على هذه الصيغة؛ وأما على صيغة الاستقبال فكقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد واصل في شهر رمضان فواصل معه قوم، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع له المتعمقون تعمقهم. وقد استعملها أبو الطيب على هذا الوجه في قوله: فجاءت في كلامه بهجة رائقة، وأما الماضي من هذه اللفظة فلم يستعمل إلا شاذاً ولا حسن لهن كقول أبي العتاهية: فلم تقع في كلامه من الحسن موقعاً، ولا أصابت من الطلاوة غرضاً؛ وهذه لفظة واحدة لم يتغير شيء من أحوالها سوى أنها نقلت من صيغة إلى صيغة، وكذلك لفظة وذر، فإنها لا تسعمل ماضية، وتستعمل على صيغة الأمر كقوله تعالى: {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا} وتستعمل مستقبلة أيضاً كقوله تعالى: {سأصليه سقر * وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر} ولم ترد في القرآن الكريم إلا على هاتين الصيغتين، وكذلك في غير القرآن الكريم من فصيح الكلام، أما في حالة المضي، فإنها أقبح من لفظة ودع، وقد استعملت ما ضية مع شذوذ، وهذه لم تستعمل أصلاً.النمط الثالث: ما تيرجح فيه الإفراد في الاستعمال على التثنية، وذلك في مثل لفظ الأخدع، فإنها يحسن استعمالها في حالة الإفراد دون النثنية؛ فمما وردت فيه مفردة فجاءت حسنة رائقةن قول الصمة بن عبد الله من شعراء الحماسة: ومما ورد فيه لفظ التثنية فجاء ثقيلاً مستكرهاً قول أبي تمام: هكذا ذكره في المثل السائر، ثم قال: وليس لذلك سبب إلا أنها جاءت موحدة في أحدهما فحسنت، وجاءت مثناة في الآخر فقبحت.النمط الرابع: ما يترجح فيه الإفراد في الاستعمال على الجمع، وذلك كلفظة الأرض، فإنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مفردة، سواء أفردت بالذكر عن السماء كما في قوله تعالى: {والله أنبتكم من الأرض نباتاً} أو قرنت بالسماء مفردة كما في قوله تعالى: {ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه} أو مجموعة كما في قوله تعالى: {الحمد لله الذي خلق السموات والأرض} ولو كان استعمالها بلفظ الجمع مستحسناً لكان هذا الموضع وشبهه به أليق لمقابلة الجمع في السموات، ولما أراد أن يأتي بها مجموعة قال: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} وكذلك لفظة البقعة، وكذلك لفظة طيف في ذكر طيف الخيال، فإنها تجمع على طيوف، وهي في حالة الإفراد من أرق الألفاظ وألطفها، فإذا جمعت زالت عنها تلك الطلاوة، وفارقتها تلك البهجة، ولذلك وردت في القرآن الكريم بلفظ الإفراد، قال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون}. ولم تزل الشعراء في القديم والحديث يستعملونه بلفظ الإفراد فيقع أحسن موقع، ولم يلموا باستعماله مجموعاً.قال في المثل السائر: ويالله العجب، من هذه اللفظة ومن أختها عدة ووزناً، وهي صيف! فإنها تستعمل مفردة ومجموعة، وكلاهما في الاستعمال حسن رائق، قال: وهذا مما لا يعلم السر فيه، والذوق السليم هو الحاكم في الفرق بين هاتين اللفظتين وما يجري مجراهما. وكذلك يجري الحكم في جميع المصادر، فإنها في حالة الإفراد أحسن منها في حالى الجمع؛ وقد جاء منها بعض ألفاظ مجموعة فجاءت غثة مستكرهة كما في قول عنترة: فالفقود جمع مصدر من قولنا: يفقد فقداً، وليس له من الرونق والطلاوة ما لمفرده، وهو لفظ فقدٍ، وإن كان جائزاً من جهة العربية.النمط الخامس: ما يترجح فيه الجمع في الاستعمال على الإفراد كلفظة اللب الذي هو العقل، فإن استعمالها بصيغة الجمع في غاية الحسن والبهجة والطلاوة، وقد ورد بهذه الصيغة في غير موضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: {وليتذكر أول الألباب} وقوله: {وما يذكر إلا أولو الألباب} إلى غير ذلك من الآيات الوارد فيها ذلك بصيغة الجمع، أما في حالى الإفراد فإنها قليلة الاستعمال مع أنها لفظة ثلاثية خفيفة على النطق، بعيدة المخارج، ليست بمستثقلة ولا مكروهة.قال في المثل السائر: وإذا تأملت القرآن الكريم ودققت النظر في رموزه وأسراره وجدت هذه اللفظة قد روعي فيها الجمع دون الإفراد، فإن أضيفت أو أضيف إليها حسن استعمالها، وساغ في طريق الفصاحة إيرادها. أما إضافتها فكقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر النساء: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من أحداكن يا معشر النساء» وأما الإضافة إليها فكقول جرير: قال في المثل السائر: فإن عريت هذه اللفظة عن الجمع والإضافة لم تأت حسنة. قال: ولا تجد دليلاً على ذلك إلا مجرد الذوق السليم؛ وكذلك لفظة كوب فإنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مجموعة، وهي وإن لم تكن مستقبحة في حالى الإفراد فإن الجمع فيها أحسن. وانظر إلى ما عليها من الطلاوة والمائية في قوله تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس من معين} وعلى هذا النحو لفظ رجاً بالقصر، ومعناه الجانب، فإنها قد وردت في القرآن بلفظ الجمع في قوله تعالى: {والملك على أرجائها} أي جوانبها، ولم تستعمل مفردة: لأن الجمع يكسبها من الحسن ما لم يوجد لها حالى الإفرادن فإن اضيفت حالة الإفراد كرجا البضر ونحوه حسنت كما في حالة الجمع.قال في المثل السائر: وليس كذلك لفظ الصوف والأصواف، وإن كان لم يرد في القرآن الكريم إلا مجموعاً حيث قال تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} لأن لفظ الصوف مستحسن في حالة الإفراد كما في حالة الجمع. قال: وإنما قبح ذكره في قول أبي تمام: لأنها جاءت مجازية في نسبتها إلى الزمان. قال: وعلى هذا النهج وردت لفظة حبر وأحبار فإنها مجموعة أحسن منها مفردةً، ولم ترد في القرآن الكريم إلا مجموعة.النمط السادس: ما يترجح فيه بعض الجموع في الاستعمال على تعض كما في جمع صائب من قولك: سهم صائب، فإنه يقال في الجمع سهام صوائب وصائبات وصيب بالتشديد، وهذهن الجموع كلها حسنة، رائقة، معجبة، دائرة على ألسنة أرباب النثر والنظم، ويقال في جمعه أيضاً صيب على وزن كتب، وهو جمع قبيح، مرفوض الاستعمال، ثقبل على النطق، جاف عن السمع، وقد استعمله أبو نواس في عشره حيث قال: فجاءت غثة كريهة نابي عن السمع، نافرة عن اللسان؛ وكذلك الجمع في قيد، فإنه يجمع على قيود، وهو جمع سائغ القبول، شائع الاستعمال؛ ويقال في جمعه أيضاً: أقياد، وهو من الجموع المستكرهة الخارجة عن الاستعمال، وقد ورد في قول عويف القوافي من أبيات الحماسة: فلم يحسن ولم يرق، وكذلك القول في جمع قبة، فإنه يجمع على قباب وهو جمع حسن دائر على ألسنة الفصحاء من أهل النظم والنثر، ويجمع أيضاً على قبب، وليس بمستحسن، وإن كان هو في الكراهة دون أقياد في جمع قيدٍ وقد استعمله ابن محكان التميمي في قوله: فلم يحسن كحسن قباب بل جاءت كريهة مستشنعة؛ وأعجب ما في هذا الباب أن الجمع قد يكون متفقاً في لفظة واحدة إلا أنها مختلفة المعنى، فيختلف الاستعمال في الجمع باختلاف المعاني، حتى لو جيء بجمع في مكان جمع لم يحسن استعماله وإن كان جائزاً من جهة العربية؛ كلفظ العين، فإنها تطلق من جملة مدلولاتها على العين الباصرة، والعين من الناس، وهو النبيه منهم، والعين الباصرة تجمع على عيون، والعين من الناس تجمع على أعيان، وقد شذ هذا الموضع على المتنبي في قوله: فجمع العين الباصرة على أعيان في الموضعين.قال في المثل السائر وكأن الذوق يأبى ذلك ولا يجد له على اللسان حلاوة وإن كان جائزاً؛ وأعجب من ذلك كله أنك ترى وزناً واحداً من الألفاظ، فتارةً تجد مفرده حسناً، وتارة تجد جمعه حسناً، وتارة تجدهما جميعاً حسنين.فما مفرده أحسن من جمعه حبرور، وهو فرخ الحبارى، فإنه يجمع على حبارير ومفرده أحسن من جمعه، وكذلك طنبور وطنابير، وعرقوب وعراقيب، وما أشبه ذلك.ومما جمعه أحسن من مفرده بهلول وبهاليل، ولهموم ولهاميم، وهذا ضد الأول. ومما مفرده حسن وجمعه حسن جمهور وجماهير، وعرجون وعراجين وما أشبه ذلك.النمط السابع: ما يترجح فيه أحد صور الوزن الواحد باختلاف بالحركة والسكون كلفظ الثالث والربع إلى العشر، فإنها في حالة سكون الوسط كلها حسنة سائغة الاستعمال، فإذا تحركت أوساطها فقلت: ثلث، وربع، وخمس، وكذلك إلى عشر، فإن الحسن من ذلك جميعه ثلاثة وهي الثلث، والخمس، والسدس، أما الربع، والسبع، والثمن، والتسع، العشر فليس كذلك في حسنه. قلت: إنما يظهر ذلك في السبع، والتسع، والعشر خاصة فإن الثقل ظاهر فيها، أما الربع والثمن فإنهما في الحسن مع تحريك الوسط كالثلث، والخمس، والسدس، وقد ورد القرآن بتحريك الوسط فيهما في سورة السناء حيث قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} وقوله: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} وأي حسن وفصاحة بعد وروده في القرآن الكريم؟النمط الثامن: ما تترجح فيه أبنية بعض أسماء الفاعلين في الاستعمال على بعض، كاسم الفاعل المبني من فعل بفتح الفاء وكسر العين؛ فإنه يبنى على فاعل وفعل بكسر العين وفعلان، نحو حمد فهو حامد، وحمد، وحمدان، وفرح فهو فرح، وفارح، وفرحان، وغضب فهو غضبان، وغاضب؛ فالأفعال الثلاثة على وزن واحد، وصيغ أسماء الفاعلين المبنية منها مختلفة في الأحسن الغالب استعماله، فحامد من حمد أحسن من حمد وحمدان، وفرح من فرح أحسن من فارح، وفرحان، وغضبان من عضب أحسن من غاضب، وإن كان جائزاً، وقد جاء بناء اسم الفاعل من فرح على فارح في قول بعض شعراء الحماسة: فلم يحسن كحسن فرح، أما ما جاء منه على وزن فعلةٍ نحو همزة ولمزة وجثمة ونومة ولكنةٍ ولحنةٍ، وما أشبه ذلك؛ فقد قال في المثل السائر: الغالب على هذه اللفظة أن تكون حسنة.النمط التاسع: ما يترجح من أوزان الأفعال بعضها على بعض كلفظة فعل وافتعل، فإن لفظة فعل لها موضع تستعمل فيه، ولفظة افتعل لها موضع تستعمل فيه، تقول: قعدت إلى فلان إذا جلست إليه، واقتعدت غارب الجمل، إذا ركبت عليه، ولا يحسن أن تقول اقتعدت إلى فلان وقعدت على غارب الجمل، وإن كان ذلك جائزاً؛ وكذلك أفعل وافعوعل فإنك تقول أعشب المكان، فإذا كثر عشبه قلت: اعشوشب، فلفظة افعوعل للتكثير، وهي على ما فيها من تكرار الحروف طيبة عذبة، وكذلك سائر ما في وزنها نحو اخشوشن المكان، واعرورقت العين، واحلولى الطعم، وما أشبه ذلك.قال في المثل السائر: وهذا كله مما أخذته بالاستقراء، وفي اللغة مواضع كثيرة من ذلك لا يمكن استقصاؤها.فانظر إلى ما يفعله اختلاف الصيغة بالألفاظ، وعليك بتفقد أمثال هذه الكلمات لتعلم كيف تضع يدك في استعمالها، فكثيراً ما يقع فحول الخطباء والشعراء في مثلها، ومؤلف الكلام من كاتب وشاعر إذا مرت به الألفاظ عرضها على ذوقه الصحيح، فما يجده الحس منها موحداً وحده، وما يجده الحس منها مجموعاً جمعه؛ وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ.الصنف الثالث المتوحش في زمن دون زمن وهو ما كان متداول الاستعمال في زمن العرب، ثم رفض وترك بعد ذلك، وبهذا لا يعاب استعماله على العرب لأنه لم يكن عندهم وحشياً، ولا لديهم غريباً، كما سيأتي التنبيه عليه، وإنما يعاب استعماله على غيرهم ممن قصر فهمهم عنه، وقلت معرفتهم به؛ وقد كان كلام العرب مشحوناً به في نظمهم ونثرهم، دائراً على ألسنتهم في مخاطباتهم ومحاوراتهم، غير معيب ولا ملوم عليه، وانظر إلى ما تضمنته خطبهم وأشعارهم من الغريب ترى ذلك غير معاب، فمن ذلك قول أبي المثلم الهذلي: وقول أعرابي في وصف إبل: كوم بهازر، مكد خناجر، عظام الحناجر، سباط المشافر، أجوافها رغاب، وأعطانها رحاب، تمنع من البهم، وتبرك للجمم. يريد بالكوم جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام، والبهازر جمع بهزرة، وهي الناقة العظيمة، والمكد جمع مكود، وهي الناقة الغزيرة اللبن، والخناجر جمع خنجور، وهي بمعنى المكود أيضاً، والعظام الحناجر: غلاظ الأعناق، وسباط المشافر أي مرسلات المشافر، والمشفر من الناقة كالجحفلة من الفرس؛ ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى وينخرط في هذا السلك؛ فهذا ومثله لا يعاب استعماله على العرب لأنه لم يكن عندهم غريباً ولا لديهم وحشياً، بل شائعاً بينهم، دائراً على ألسنتهم في نظمهم ونثرهم؛ وأعظم شاهد لاستحسان استعماله عندهم ووضوح منهجه لديهم أن القرآن الكريم الذي هو أفصح كلام وأبهج لفظ قد اشتمل على ألفاظ من ذلك، كقوله تعالى: {ويقذفون من كل جانب * دحوراً ولهم عذاب واصب} وقوله: {إن الإنسان لربه لكنود} وما أشبه ذلك، وهذه الألفاظ كانت مفهومة عند العرب، معلومة المعاني عند المخاطبين: لأن الله تعالى قد خاطبهم به وأمرهم فيه ونهاهم، والخطاب بما لا يفهم بعيد، وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}. وكذلك ورد في الأخبار النبوية جملة مستكثرة من ذلك، وهي المعبر عنها بغريب الحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة» أي نقص، وقيل تبعة، وقيل حسرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليسترجع أحدكم حتى في شسع نعله فإنها من المصائب» والشسع: أحد سيور النعل؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها، وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: «واغسل حوبتي واسلل سخيمة قلبي» وأشباه ذلك.وحديث أم زرع صريح في شيوع ذلك فيهم، وعمومه في مخاطباتهم ومكالماتهم؛ وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً.قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقى، وفي رواية فينتقل.قالت الثانية: زودي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق.قالت الرابعة: زودي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا خوف ولا سآمة.قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف، ليعلم البث.قالت السابعة: زوجي غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلالك.قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب.قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي.قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح، كثيرات المبارك، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت نفسي، ووجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق؛ فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتفتح، وفي رواية فأتقمح؛ أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح؛ ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة؛ بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، وطوع أمها، وملء كسائها، وغليظ جارتها؛ جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تنث حديثنا تنثيثاً وفي رواية لا تبث حديثنا تبثيثاً، ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً، ولا تملأ بيتنا تعشيشاً. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلاً سرياً، ركب شرياً، وأخذ خطياً، وأراح علي نعماً ثرياً، وأعطاني من كل رائحة زوجاً، وفي رواية فأعطاني من كل ذابحة زوجاً وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وفي رواية: «غير أني لا أطلقك».فإذا كان هذا كلام نسائهم الدائر فيما بينهن من محادثاتهن مع بعضهن في خلواتهن، فما ظنك بفرسان الكلام في نظمهم ونثرهم! فأنى يعاب عليهم ذلك، وينكر عليهم الإتيان بمثله! وقد اختصم رجل وامرأة إلى يحيى بن يعمر، وهو من أكابر التابعين وجلتهم، فقال للرجل: أأن سألتك ثمن شكرها وشبرك، أنشأت تطلها وتضهلها؟ أما غير العرب ممن تكلف ذلك وأتى به في كلامه المعتاد في مخاطباته أو نثره ونظمه فإنه يعاب عليه ذلك، وينحط به عن درجة الفصاحة، ويخرج به عن قانونها، إذ المقصود من الكلام إنما هو الإفهام لا غير، فيخاطب كل أحد بما يفهمه ولا يكلف بما لا يعلمه، وخير الكلام ما جاد وأفاد.قال بشر بن المعتمر: إياك والتوعر، فإنه يسلمك إلى التعقيد والتقييد، وهو الذي يستهلك معانيك ويمنعك مراميك.قال أبو هلال العسكري: وربما غلب سوء الرأي وقلة العقل على بعض علماء العربية فيخاطبون السوقي، والمملوك والأعجمي، بألفاظ أهل نجد، ومعاني أهل السراة وحكاياتهم في ذلك كثيرة.قال أبو نصر الجوهري: سقط عيسى بن عمر عن حمار له فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة! افرنقعوا عني. أي ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على ذي جنة تفرقوا عني. وذكر الجاحظ هذه الحكاية عن أبي علقمة النحوي بزيادة فقال: مر أبو علقمة ببعض طرق البصرة فهاجت به مرة فوثب عليه قوم يعضون إبهامه ويؤذنون في أذنه، فأفلت من أيديهم وقال: ما لكم تكأكأتم علي كما تكأكؤون على ذي جنة! افرنقعوا عني. فقال بعضهم: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية.وقال أبو علقمة يوماً لحاجمه: اشدد قصب اللهازم، وأرهف ظبات المشارط، وأمر المسح، واستنجل الرشح، وخفف الوطء، وعجل النزع، ولا تكرهن أبياً، ولا تردن أتياً؛ فقال له الحجام: ليس لي علم بالحروف.ونظر إليه رجل وتحته بغل مصري حسن المنظر، فقال: إن كان مخبر هذا البغل كمنظره فقد كمل، فقال أبو علقمة: والله لقد خرجت عليه من مصر فتنكبت الطريق مخافة السراق وجور السلطان، فبينا أنا أسير ي ليلة ظلماء قتماء، طحياء مدلهمة، حندس داجية، في صحصح أملس، إذ أحس بنبأة من صوت نغر، أو طيران ضوع، أو نغض سبد فحاص عن الطريق متنكباً لعزة نفسه، وفضل قوته، فبعثته باللجام فعسل، وحركته بالركاب فنسل؛ وانتعل الطريق يغتاله معتزماً، والتحف الليل لا يهابه مظلماً، فوالله ما شبهته إلا بظبية نافرة تحفزها فتخاء شاغية؛ فقال الرجل: فادع الله وسله أن يحشر معك هذا البغل يوم القيامة، قال: ولم؟ قال: ليجيزك الصراط بطفرة.وكانت امرأة تأكل الطين فحصل لها بسببه إسهال مرضت منه، وكان لها ولد يتكلم بالغريب، فكتب رقاعاً وطرحها في المسجد الجامع بمدينة السلام فيها: صين امرؤ ورعي، دعا لامرأة إنقحلة مقسئنة قد منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصال أن يمن الله عليها بالاطرغشاش. فكل من قرأ رقعته، دعا عليه ولعنه ولعن أمه.وحكى محمد بن أبي المغازي الضبي عن أبيه قال: كان لنا جار بالكوفة لا يتكلم إلا بالغريب، فخرج إلى ضيعة له على حجر معها مهر فأفلتت، فذهبت ومعها مهرها فخرج يسأل عنها، فمر بخياط فقال: يا ذا النصاح وذات السم، الطاعن بها في غير وغي لغير عدى، هل رأيت الخيفانة القباء يتبعها الحاسن المسرهف؟ كأن غرته القمر الأزهر، ينير في حضره كالخلب الأجرد؟ فقال الخياط: اطلبها في ترللج؛ فقال: ويحك ما تقول، قبحك الله! فإني ما أعرف رطانتك؛ قال: لعن الله أبغضنا لفظاً وأخطأنا منطقاً.وضرب عمر بن هبيرة عيسى بن عمر النحوي ضرباً كثيراً من أجل وديعة فكان يقول وهو يضرب: ما هي إلا أثياب في أسفاط أخذها عشاروك وسأله رجل عن مسألة. فقال: ليست مسألتك يتنا. أي ليست مستوية؛ وأصل اليتن: خروج رجل الولد قبل رأسه. وسأله آخر عن كتابته، فقال: كتبت حتى انقطع سوائي أي ظهري، على أن أبا جعفر النحاس قد عد عيسى بن عمر من المطبوعين في ذلك. قال الجاحظ: رأيتهم يديرون كتبهم هذا الكلام، فإن كانوا إنما رووه ودونوه لأنه يدل على فصاحة وبلاغة غريب فأبيات من شعر العجاج وشعر الطرماح وأشعار هذيل تأتي لهم مع الرصف الحسن على أكثر من ذلك. فلو خاطب أحد الأصمعي بمثل هذا الكلام، لظننت أنه يستجهل نفسه، وهذا خارج عن عادة البلغاء.الصنف الرابع: الغريب المتوحش عند قوم دون قوم:وذلك ككلام أهل البادية من العرب بالنسبة إلى أهل الحضر منهم، فإن أهل الحضر يألفون السهل من الكلام، ويستعملون الألفاظ الرقيقة، ولا يستعملون الغريب إلا في النادر؛ وأهل البادية يألفون اللفظ الجزل ويميلون إلى استعمال الغريب؛ وإذا نظرت إلى أهل مكة وكلام قريش الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرومتهم، وكلام أهل حضرموت وما جاورها من اليمن ومخاليف الحجاز، علمت فرق ما بين الكلامين، وتباين ما بين الطرفين، حتى كأن البادي يرطن بالنسبة إلى الحاضر، ويتكلم بلغة غير العربية؛ وكانت لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكلم بها على الدوام، ويخاطب بها الخاص والعام، لغة قريش وحاضرة الحجاز، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجمع إلى سهولة الحاضرة جزالة البادية، فكان يخاطب أهل نجد وتهامة وقبائل اليمن بلغتهم، ويخاطبهم في الكلام الجزل على قدر طبقتهم.فمن ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم لطهفة النهي وكتابه إلى بني نهد، وذلك أنه لما قدم وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه طهفة بن أبي زهير النهدي، فقال: أتيناك يا رسول الله نم غور تهامة على أكوار الميس، ترتمي بنا العيس، نستحلب الصبير، ونستجلب الخبير ونستعضد البرير، ونستخيل الرهام، ونستخيل الجهام؛ من أرض غائلة النطاء، غليظة الوطاء؛ قد جف المدهن، ويبس الجعثن؛ وسقط الأملوج، ومات العسلوج؛ وهلك الهدي، وفاد الودي؛ برئنا إليك يا رسول الله من الوثن والعثن، وما يحدث الزمن، لنا دعوة السلام، وشريعة الإسلام، ما طما البحر، وقام تعار، ولنا نعم همل أعفال، ما تبض ببلال، ووقير كثير الرسَل، قليل الرسْل، أصابتها سنية حمراء مؤزلة، ليس لها علل ولا نهل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها وفرقها، وابعث راعيها في الدثر بيانع الثمر، وافجر لهم الثمد، وبارك لهم في المال والولد؛ من أقام الصلاة كان مسلماً، ومن آتى الزكاة كان محسناً، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، ووضائع الملك؛ لا تلطط في الزكاة، ولا تلحد في الحياة، ولا تتثاقل عن الصلاة».وكتب معه كتاباً إلى بني نهد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم! السلام على من آمن بالله ورسوله، لكم يا بني نهد في الوظيفة الفريضة، ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب، والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم، ولا يعضد طلحكم، ولا يمنع دركم، ما لم تضمروا الإمق، وتأكلوا الرباق؛ من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة.ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة همدان، وذلك أنه لما قدم عليه صلى الله عليه وسلم وفود العرب قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مالك بن نمط أبو ثور، وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع، وضمام بن مالك السلماني، وعميرة بن مالك الخارقي، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعهم من تبوك، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية، برحال الميس على المهرية والأرحبية، ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم، يقول أحدهما: ويقول آخر: فقام مالك بن نمط بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، نصية من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلص نواج متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف خارف، ويام، وشاكر؛ أهل السواد والقرى، أجابوا دعوة الرسول، وفارقوا آلهة الأنصاب، عهدهم لا ينقض ما أقام لعلع، وما جرى اليعفور بصلع.فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم! هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخلاف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل، مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط، ولمن أسلم من قومه، على أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، يأكلون علافها ويرعون عافيها؛ لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار».فقال في ذلك مالك بن نمط: وفي رواية أن في كتابه إليهم: «إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها؛ لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب، والفصيل والفارض، والداجن والكبش الحوري، وعليهم فيها الصالغ والقارح».ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم لأكيدر دومة. قال أبو عبيدة: أنا قرأته فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم! من محمد رسول الله، لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام، مع خالد بن الوليد، سيف الله في دومة الجندل وأكنافها، إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض، والحلقة والسلاح والحافر والحصن، ولكم الضامنة من النخل، والمعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم، ولا تعد فاردتكم، ولا يحظر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها، وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك عهد الله والميثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد الله ومن حضر من المسلمين».ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى وائل بن حجر وأهل حضرموت، وهو «بسم الله الرحمن الرحيم! من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، على التيعة الشاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط، ولا شناق ولا شغار؛ ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام».وفي رواية أنه كتب إليهم: «إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، وفي التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك، وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس؛ ومن زنى من امبكر فاصقعوه مائة، واستوفضوه عاماً؛ ومن زنى من امثيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين، ولا عمة في فرائض الله تعالى؛ وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على الأقيال».قال الوزير ضياء الدين بن الأثير رحمه الله في المثل السائر: وفصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتضي استعمال هذه الألفاظ، ولا تكاد توجد في كلامه إلا جواباً لمن يخاطبه بمثلها كحديث طهفة وما جرى مجراه؛ على أنه قد كان في زمنه أولاً متداولاً بين العرب ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا يسيراً لأنه أعلم بالفصيح والأفصح.الصفة الثانية اللفظ الفصيح ألا يكون مبتذلاً عامياً، ولا ساقطاً سوقياً واللفظ المبتذل على قسمين:القسم الأول ما لم تغيره العامة عن موضعه اللغوي إلا أنها اختصت باستعماله دون الخاصة فابتذل لأجل ذلك وسخف لفظه، وانحطت رتبته لاختصاص العامة بتداوله، وصار من استعمله من الخاصة ملوماً على الإتيان به لمشاركة العامة فيه؛ وقد وقع ذلك لجماعة من فحول الشعراء فعيب عليهم.فمن ذلك قول الفرزدق من قصيدة: فقوله مندف من الألفاظ العأمية المبتذلة، وإن كان له أصل في اللغة، يقال ندف القطن إذا ضربه بالمندف، ولذلك قيل للقطن المندوف: نديف.ومن ذلك قول أبي نواس: فالشطار جمع شاطر، وهو في أصل اللغة اسم لمن أعيا أهله خبثاً؛ يقال منه: شطر وشطر بالفتح والضم شطارة بالفتح فيهما، ثم استعمل في الشجاع الذي أعيا الناس شجاعة، وغلب دورانه على لسان العامة فامتهن وابتذل؛ فاستعمال أبي نواس له غير لائق، وكذلك قوله أيضاً: فلفظ القرلى من أشد ألفاظ العامة ابتذالاً، وهو اسم لطائر صغير من طيور الماء يخطف صغار السمك من الماء برجليه ومنقاره، فإذا سقط على الماء ولم يحصل على صيد ارتفع بسرعة، فتضرب به العامة المثل تقول: فلان كأنه قرلى، إن وجد خيراً تدلى، وإن وجد شراً تعلى.وقوله أيضاً: فقوله: قاقا حكاية لصوت يضرب به المثل لصياح المغلوب، يقال: فعلت بفلان كذا وكذا حتى قال: قاق؛ وأقبح من ذلك كله في الابتذال بين العامة والسخافة قول المتنبي: قال في المثل السائر: وهذا البيت من مضحكات الأشعار وهو من جملة البرسام الذي ذكره في قوله: وعد منه في المثل السائر قول البحتري: قال: فلفظة الزاج من أشد ألفاظ العامة ابتذالاً، وكذلك عد منه قول النابغة الذبياني: قال فلفظة آجر مبتذلة جداً. وإذا شئت أن تعلم شيئاً من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن الكريم، فانظر إلى هذا الموضع فإنه لما جيء فيه بذكر الآجر لم يذكر بلفظه، ولا بلفظ القرمد أيضاً، ولا بلفظ الطوب الذي هو لغة أهل مصر، فإن هذه الأسماء مبتذلة، لكن ذكر في القرآن على وجه آخر، وهو قوله تعالى: {وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً} فعبر عن الآجر بالوقود على الطين؛ نعم من الألفاظ المبتذلة السخيفة لفظة الكنس، وما اشتق منه، ولذلك عابها القاضي الفاضل رحمه الله تعالى على ابن سناء الملك في بعض أشعاره حيث قال من أبيات: فلما وقف القاضي الفاضل رحمه الله على هذا القصيدة كتب إلى ابن سناء الملك من جملة فصل: وما قلت هذه الغاية، إلا وتعلمني أنها البداية، ولا قلت هذا البيت آية القصيدة إلا تلا ما بعده: وما نريهم من آية. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولا عيب في هذه المحاسن إلا قصور الأفهام، وتقصير الأنام، وإلا فقد لهج الناس بما تحتها، ودونوا ما دونها، وشغلوا التصانيف والخواطر والأقلام بما لا يقاربها، وسارت الأشعار وطالت بما لا يبلغ مدها ولا نصيفه؛ والقصيدة فائقة في حسنها، بديعة في فنها؛ وقد ذلت السين فيها وانقادت، فلو أنها الراء لما رادت؛ وبيت يعزل ويكنس أردت أن أكنسه من القصيدة، فإن لفظه الكنس غير لائقة في مكانها.فأجابه ابن سناء الملك قائلاً: وعلم المملوك ما نبه عليه مولانا من البيت الذي أراد أن يكنسه من القصيدة، وقد كان المملوك مشغوفاً بهذا البيت، مستحلياً له متعجباً منه، معتقداً أنه قد ملح فيه، وأن قافية بيته أميرة ذلك الشعر وسيدة قوافيه، وما أوقعه في الكنس إلا ابن المعتز في قوله: والمولى يعلم أن المملوك لم يزل يجري خلف هذا الرجل ويتعثر، ويطلب مطالبه فتتعسر عليه وتتعذر؛ ولا آنس ناره إلا لما وجد عليها هدى، ولا مال المملوك إلا إلى طريق من ميله إليه طبعه؛ ولا سار قلبه إلا إلى من دله عليه سمعه؛ ورأى المملوك أبا عبادة قد قال: وقال: فعلم المملوك أن هذه طريقة لا تسلك، وعقيلة لا تملك، وغاية لا تدرك؛ ووجد أبا تمام قد قال: وقال: فاشمأز من هذا النمط طبعه، واقشعر منه فهمه، ونبا عنه ذوقه، وكاد سمعه يتجرعه ولا يكاد يسيغه؛ ووجد هذا السيد عبد الله بن المعتز قد قال: وقال: فوجد المملوك طبعه إلى هذا النمط مائلاً، وخاطره في بعض الأحيان علي سائلاً؛ فنسج على هذا الأسلوب، وغلب عليه خاطره مع علمه أنه المغلوب؛ «وحبك الشيء يعمي ويصم» فقد أعماه حبه وأصمه إلى أن نظم تلك اللفظة في تلك الأبيات تقليداً لابن المعتز حيث قالها، وحمل أثقالها؛ وهي تغفر لذاك في جنب إحسانه، فأما المملوك فهي عورة ظهرت من لسانه.فأجابه القاضي الفاضل رحمه الله بقوله: ولا حجة فيما احتج به عن الكنس في بيت ابن المعتز، فإنه غير معصوم من الغلط، ولا يقلد إلا في الصواب فقط، وقد علم ما ذكره ابن رشيق في عمدته من تهافت طبعه، وتباين وضعه، فذكر من محاسنه ما لا يعلق معه كتاب، ومن بارده وغثه ما لا تلبس عليه الثياب.وقد تعصب القاضي السعيد على أبي تمام فنقصه من حظه، وللبحتري فأعطاه أكثر من حقه، وما أنصفهما: قال المولى صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى في شرح لأمية العجم: وقد استعمل ابن سناء الملك رحمه الله تعالى هذه اللفظة في غير هذا الموضع ولم يتعظ بنهي الفاضل ولا أرعوى ولا ازدجر عما قبحه لأن غلب عليه الهوى، فقال: قال: وأما القاضي الفاضل، فما أظنه خلا في هذا الإيراد، من ضعف انتقاد؛ وأحاشي ذاك الذهن الوقاد، من هذا الاعتقال في ورطة هذا الاعتقاد؛ وما أراه إلا أنه تعمد أن يعكس مراده، ويوهي ما شده ويوهن ما شاده؛ ويرميه ببلاء البلادة؛ إما على سبيل النكال أو النكادة، لأن الفاضل رحمه اله ممن يتوخى هذه الألفاظ ويقصدها، وينشيها وينشدها، ويوري زنادها ويوردها.فمن كلام القاضي الفاضل في بعض رسائله: وما استطاعت أيديهم أن تقبض جمره، ولا ألبابهم أن تسيغ خمره، ولا سيوفهم أن تكنس قميمه.قال في المثل السائر: ومثل هذه الألفاظ إذا وردت في الكلام، وضعت من قدره ولو كان معناه شريفاً. قال: وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لا يكاد يخلوا منه شعر شاعر، لكن منهم المقل ومنهم المكثر.القسم الثاني ما كان من الألفاظ دالاً على معنى وضع له في أصل اللغة فغيرته العامة وجعلته دالاً على معنى آخر. وهو على ضربين:الضرب الأول: ما ليس بمستقبح في الذكر ولا مستكره في السمع:وذلك كتسميتهم الإنسان إذا كان دمث الأخلاق، حسن الصورة أو اللباس أو ما هذا سبيله ظريفاً، والظرف في أصل اللغة: مختص بنطق اللسان فقط، كما أن الصباحة مختصة بالوجه، والوضاءة مختصة بالبشرة، والجمال مختص بالأنف، والحلاوة مختصة بالعينين، والملاحة: مختصة بالفم، والرشاقة: مختصة بالقد، واللباقة: مختصة بالشمائل؛ فالظرف إنما يتعلق بالنطق فغيرته العامة عن بابه ونقلته إلى أعم من موضوعه كما تقدم؛ وممن وقع له الذهول عن ذلك فغلط فيه أبو نواس في قوله: فوصف الوجه بالظرف، وهو من صفات النطق كما تقدم؛ وكذلك أبو تمام في قوله: فوصف الشيم بالحلاوة وهي مختصة بالعينين، ووصف الخلق بالظرف وهو مختص بالنطق كما تقدم بيانه.الضرب الثاني: ما يستقبح ذكره:كما في لفظ الصرم بالصاد المضمومة والسرم بالسين؛ فإن الصرم بالصاد في أصل اللغة عبارة عن القطع، يقال: صرمه يصرمه صرماً وصرماً بالفتح والضم إذا قطعه، وبالسين عبارة عن المحل المخصوص، وقد كانت العرب تستعمله بالصاد المضمومة في أشعارها بهذا المعنى فلا يعاب عليها؛ قال أبو صخر الهذلي: فاستعمله بمعنى القطع ولم يعب عليه لأن الألفاظ في زمن العرب لم تتغير بل كانت باقية على أوضاعها الأصلية، فقلبت العامة السين من المحل المخصوص صاداً واستعملت لفظ الصرم الذي هو القطع في المحل المخصوص، فصار لفظه مستقبحاً وسماعه مستكرهاً، وعيب على أبي الطيب استعماله في قوله: على أنه إنما يكره استعماله بصيغة الاسم لما تقدم، أما إذا استعمل بصيغة الفعل مثل صرم ويصرم وما شاكل ذلك، فإنه لا حجر في استماله، وقد استعمله ابن الرومي بالسين على بابه فجاء أقبح وأشنع، فقال يهجو الورد: قال الصلاح الصفدي: وأين هذا التشبيه القبيح من قول الأخر في الورد أيضاً: قال: فانظر إلى هذا: وجنة، وحبيب، ودينار، وإلى ذلك: سرم، وبغل، وروث. وشتان ما بينهما.الصفة الثالثة من صفات اللفظ المفرد الفصيح ألا يكون متنافر الحروف، فإن كانت حروفه متنافرة بحيث يثقل على اللسان ويعسر النطق به فليس بفصيح وذلك نحو لفظ الهعخع في قول بعض العرب عن ناقة: تركتها ترعى الهعخع بالخاء المعجمة والعين المهملة، وهو نبت أسود، وكذلك لفظ مستشزرات من قول امرئ القس في قصيدته اللأمية التي من جملة القصائد السبع الطوال: فلفظ مستزرات من المتنافر الذي يثقل على اللسان، ويعسر النطق به. قال الوزير ضياء الدين بن الأثير رحمه الله في المثل السائر: ولقد رآني بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذا اللفظ فأكبر ذلك لوقوفه مع شبهة التقليد في أن امرأ القيس أشعر الشعراء، فعجبت من ارتباطه بمثل هذه الشبهة الضعيفة، وقلت له: لا يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ماله من القبيح، بل مثال ذلك كمثال غزال المسك فإنه يخرج منه المسك والبعر، ولا يمنع طيب ما يخرج من مسكه من خبث ما يخرج من بعره، ولا تكون لذاذة ذلك الطيب حأمية للخبيث من الاستكراه، فأسكت الرجل عند ذلك. إذا علمت ذلك، فإن معظم اللغة العربية دائرة على ذلك، لأن الواضع هو الأكثر، ولا يوجد فيه ما يكره استعماله غلا النادر؛ والخماسي هو الأقل، ولا يوجد فيه ما يستعمل إلا الشاذ النادر؛ والرباعي وسط بين الثلاثي والخماسي في الكثرة عدداً واستعمالاً، فيكون أكثر اللغة مستعملاً غير مكروه. قال: ولا تقتضي حكمة هذه اللغة التي هي سيدة اللغات إلا ذلك؛ ولذلك أسقط الواضع منها حروفاً كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالاً واستكراهاً، فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والعين، وكذلك لم يؤلف بين الجيم والقاف، ولا بين اللام والراء، ولا بين الزاي والسين، وذلك دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج دون المتقارب؛ وكيف كان الواضع يخل بمثل هذا الأصل الكلي في تحسين اللغة وقد اعتنى بأمور جزئية دون ذلك؟؟ كمماثلته بين حركات الفعل في الوجود وبين حركات المصدر في النطق كالغليان، والضربان، والنقزان، والنزوان، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، فإن جميع حروفه متحركات ليس فيها حرف ساكن، وهي مماثلة لحركات الفعل في الوجود.ومن نظر في حكمة وضع هذه اللغة إلى هذه الدقائق التي هي كالأطراف والحواشي فكيف كان يخل بالأصل المعول عليه في تأليف الحروف بعضها إلى بعض!. على أنه لو أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ، أهي متباعدة أو متقاربة، لطال الخطب في ذلك وعسر، ولما كان الشاعر ينظم قصيداً، ولا الكاتب ينشئ كتاباً إلا في مدة طويلة، والأمر بخلاف ذلك، فإن حاسة السمع هي الحاكمة في هذا المقام في تحسين لفظ وتقبيح آخر؛ على أنه قد يجيء من المتقارب المخارج ما هو حن رائق، ألا ترى أن الحروف الشجرية، وهي الجيم والشين والياء، متقاربة المخارج لأنها تخرج من وسط اللسان بينه وبين الحنك، وإذا ترتب منها لفظ جاء حسناً رائقاً، فإن لفظة جيش قد اجتمع فيها الحروف الشجرية الثلاثة، وهي مع تقارب مخارجها حسنة رائقة؛ وكذلك الحروف الشفهية وهي الباء والميم والفاء متقاربة المخارج، فإن مخرج جميعها من الشفة؛ وإذا ترتب منها لفظ جاء سلساً غير متنافر، كقولك أكلت بفمي، وهو في غاية الحسن، والحروف الثلاثة الشفهية مع تقارب مخارجها مجتمعة فيها؛ وقد يجيء من المتباعد المخارج ما وقبيح متنافر، كقولك: ملع بمعنى عدا، فإن الميم من الشفة، والعين من حروف الحلق، واللام من وسط اللسان؛ فهذه الحروف كلها متباعدة من بعضها ومع ذلك فإنها كريهة الاستعمال، ينبو عنها الذوق السليم، ولو كان التباعد سبباً للحسن لما كان سبباً للقبح؛ على أنه لو عكست حروف هذه اللفظة صارت علم وعاد القبح منها حسناً؛ مع أنه لم يتغير شيء من مخارجها، على أن اللام لم تزل فيها وسطاً والميم والعين تغيرت هذه اللفظة بتقديم بعض الحروف وتأخير بعض، وليس ذلك لأن إدخال الحروف من الشفة إلى الحلق في ملع أعسر من إخراجها من الحلق إلى الشفة في علم، فإن لفظة بلع فيها الباء وهي من حروف الشفة، واللام وهي من وسط اللسان، والعين وهي من حروف الحلق وهي غير مكروهة.قال في المثل السائر: ولربما اعترض بعض الجهال بأن الاستثقال في لفظ مستشزرات إنما هو لطولها وليس كذلك، فإنا لو حذفنا منها الألف والتاء وقلنا مستشزر لكان ثقيلاً أيضاً، لأن الشين قبلها تاء وبعدها زاي؛ فثقل النطق بها؛ نعم لو أبدلنا من الزاي راء ومن الراء فاء فقلنا مستشرف لزال ذلك؛ ومن ثم ظهر لك أن اعتبار ابن سنان تركيب الكلمة من أقل الأوزان تركيباً غير معتبر، وقد ورد في القرآن العظيم ألفاظ طوال لا شك في حسنها وفصاحتها كقوله تعالى: {فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم} وقوله تعالى: {ليستخلفنهم في الأرض} فإن لفظ فسيكفيكهم مركب من تسعة أحرف، ولفظ ليستخلفنهم مركب من عشرة أحرف، ولفظ مستشزرات مركب من ثمانية أحرف. قال: والأصل في هذا الباب أن الأصول لا تحسن إلا من الثلاثي وفي بعض الرباعي، كقولك عذب وعسجد، فالأولى ثلاثية، والثانية رباعية؛ أما الخماسي من الأصول فإنه قبيح، كقولك: صهصلق وجحمرش، وما جرى مجراهما؛ ولهذا لا يوجد في القرآن الكريم من الخماسي الأصول شيء إلا ما كان من اسم نبي عرب اسمه، ولم يكن في الأصل عربياً كإبراهيم وإسماعيل ونحوهما.الصفة الرابعة من صفات اللفظ المفرد الفصيح ألا يكون على خلاف القانون المستنبط من تتبع مفردات ألفاظ اللغة العربية وما هو في حكمها كوجوب الإعلال في نحو قام والإدغام في نحو مد، وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريف، فإنه لو فك الإدغام في مد فقال مدد لم يكن فصيحاً، وعلى حد ذلك جاء قول بعض العرب: فإن قياس بابه الإدغام فيقال الأجل.قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح التلخيص: وأما نحو أبى يأبى وعور واستحوذ وقطط شعره وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة فليست من المخالفة في شيء لأنها كذلك ثبتت عن الواضع، فهي في حكم المستثناة.فهذه الصفات الأربع هي عمود الفصاحة في اللفظ المفرد، وقطب دائرة حسنة، فمتى اتصف بها وسلم من أضدادها كان بالفصحاة متسماً، وبالحسن والرونق مشتملاً، وللطبع ملائماً، وللسمع موافقاً؛ ومتى عزي عن ذلك خرج عن الطبع، ورفضته النفوس، ونفرت منه القلوب، فلزم العيب قائله، وتوجه العتب على مستعمله.قال ابن الأثير رحمه الله: وقد رأيت جماعة من الجهال إذا قيل لأحدهم: إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك وقال: بل كل الألفاظ حسن، والواضع العسلوج، وبين لفظ المدامة ولفظ الإسفنط، وبين لفظ السيف ولفظة الخنشليل، وبين لفظة الأسد ولفظة الفدوكس؛ فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب، ولا يجاب بجواب، بل يترك وشأنه كما قيل: أتركوا الجاهل بجهله، ولو ألقى الجعر في رحله.وما مثاله في ذلك إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد، شوهاء الخلق، ذات عين محمرة، وشفة غليظة، وشعر قطط، وبين صورة رومية بيضاء، مشربة بحمرة، ذات خد أسيل، وطرف كحيل، ومبسم كأنما نظم من أقاح، وطرة كأنها ليل على صباح. فإذا كان بإنسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه، فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه، ولا فرق بين السمع والنظر في ذلك؛ فإن هذه حاسة وهذه حاسة، وقياس حاسة على حاسة غير ممتنع؛ ولا عبرة بمن يستحسن الألفاظ القبيحة، ويميل إلى الصورة الشنيعة؛ فإن الحكم على الكثير الغالب، دون الشاذ النادر الخارج عن الاعتدال؛ فإنا لو رأينا من يحب أكل الفحم والجص والتراب، ويختار ذلك على ملاذ الأطعمة فإنا لا نستجيد هذه الشهوة بل نحكم عليه بالمرض وفساد المعدة، وأنه يحتاج إلى العلاج والمداواة؛ ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة الأوتار، وصوتاً منكراً كصوت الحمار، وأن لها في الفم حلاوة كحلاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل. ولا حجة لاستعمال العرب لهذه الألفاظ، فإن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب، لأنه ليس للتقليد فيه مجال؛ وإنما له خصائص وهيئات وعلامات إذا وجدت علم حسنه من قبحه. الله أعلم.
|